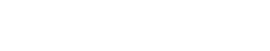المغرب: قضية بوعشرين ليست مع الملك بل مع «مسامر المايدة» (حوار) – اليوم 24


في هذا الحوار مع الدكتور علاء الدين بنهادي، الديبلوماسي السابق، وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، نتطرق إلى عدد من القضايا السياسية والاجتماعية الراهنة، وحالة الاحتقان التي تسود الشارع المغربي، وعلاقة ذلك بالمؤسسات الوسيطة والمؤسسة الملكية.هناك شبه إجماع اليوم على وجود حالة فراغ سياسي في المغرب، يقابلها احتقان اجتماعي ووعي سياسي شعبي متقد، إلى ما ترد ذلك، وما تأثيره السلبي في أي انتقال ديمقراطي محتمل؟ حالة الفراغ السياسي هي تعبير عن أزمة السلطة المركزية وضعفها أمام المسؤوليات المنوطة بها دستوريا ومشروعيا، وهي مرحلة تسبق حالة من الاضطراب العام في مفاصل الدولة ووظائفها وتعرض السلطة الحاكمة لاختبار الشرعية والبقاء، فراغ ينتج عنه احتقان اجتماعي بسبب عجز مؤسسات الدولة في الاستجابة لحاجيات الناس وغياب أي دور للأحزاب السياسية والهيئات النقابية والوسيطة في التخفيف من حالة هذا الاحتقان وإكراه السلطة الحاكمة على القيام بواجباتها الدستورية. هناك فراغ عام دب في جسد دولة أتعبها الصراع حول السلطة منذ فترة وفقدت وظائفها الطبيعية.يشبه الوضع الحالي المرحلة العزيزية مطلع القرن العشرين على أكثر من مستوى، إذ اتسم الحكم، بعد الوفاة المفاجئة للسلطان الحسن الأول أواخر القرن التاسع عشر، بحالة من الضعف والصراع الداخلي والاضطرابات الاجتماعية والأطماع الأجنبية انتهت بتوقيع اتفاقية الجزيرة الخضراء عام 1906، ثم اتفاقية فاس الاستعمارية عام 1912 لحماية العرش والأسرة الملكية كما جاء في الوثيقة، رافقهما على التوالي عزل وخلع السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ، كما رافق هذا الفراغ والضعف في السلطة ثورات عارمة انتشرت في جميع مناطق المغرب، الخطابي والريسوني والزرهوني والزياني إلى منتصف القرن حيث اندلعت ثورة شيخ العرب، أحمد أجوليز، وحالات من التمرد في قبائل آيت باعمران والثورة المسلحة لعدي وبيهي وأحمد الحنصالي وانتفاضة محمد الحاج سلام أمزيان. حالة التمزق هذه لا ترشح السلطة الحاكمة لقيادة أي تحول نحو الديمقراطية، لأنها ترى فيها إضعافا لها وتقليلا لامتيازاتها، ولا بالاستفراد بحياة الرغد فيما عموم الشعب يغلي وفي حالة غضب غير مهيكل في غياب مؤسسات المجتمع السياسي، أحزاب ونقابات وهيئات وسيطة وشخصيات مستقلة، غضب قد يخرج عن السيطرة وينفلت الوضع نحو المجهول.نحن لسنا أمام فراغ سياسي وإنما أمام فراغ في السلطة الحاكمة، وهي المؤسسة الملكية، فراغ أوجده صراع أقطابها وأجنحتها الفاعلة في الحلقة الضيقة والمقربة من الجالس على العرش، أحدها يجر نحو توحش السلطة ومواجهة عموم الشعب والنخبة المعارضة الجديدة غير التقليدية بمئات السنين من الأحكام القاسية، تستعمل فيها أدوات غير قانونية وغير أخلاقية للنيل من هذه المعارضة وإسكاتها وراء القضبان وإفلاس مشاريعها الصحفية، حالات مثل أبو بكر الجامعي وعلي لمرابط وعلي أنوزلا وتوفيق بوعشرين وحميد المهداوي، وتصفية مكانتها الاجتماعية والاعتبارية ليس وفق قواعد شرف الخصومة، ولكن عبر بناء ملفات وتنزيل قوانين، مكافحة الإرهاب والاتجار في البشر، على مقاس المعارضة الاقتراحية الجديدة لتدميرها وقطع الطريق أمام أي تعاطف وطني أو دولي معها. أما الطرف الثاني في نفس الدائرة، وهو الحلقة الأضعف، فيعمل على ألا تصطدم الملكية بالمعارضة الشعبية والنخبوية غير التقليدية وغير المهيكلة، بعد أن لم يبق للأحزاب والنقابات والهيئات الوسيطة أي دور يذكر بسبب سياسات الجناح المتطرف في السلطة الذي سفهها وجعلها مسخا بلا مشروعية ولا هوية ولا مصداقية.بدأنا نرى، من حين لآخر، مواطنين يوجهون انتقادات مباشرة إلى المؤسسة الملكية، هل يعبر ذلك عن حالة قصوى من الغضب العفوي، أم يتضمن دعوة ضمنية واعية للقطع مع الملكية التنفيذية؟هذه نتيجة طبيعية وتطور دراماتيكي مدمر لسياسات السلطة الحاكمة وللجناح اليميني الاستئصالي الذي يستفرد بها اليوم، ويقرر توجهاتها نحو المزيد من الاصطدام مع الشعب ونخبته المعارضة الجديدة. إن إلغاء دور الأحزاب والجامعات والنقابات وهيئات المجتمع المدني الوسيطة المستقلة والصحافة الحرة وقطاع الثقافة في تنشئة الشباب من قبل السلطة الحاكمة، كان طبيعيا أن يضع الملكية والشعب، خاصة المقهور منه، وجها لوجه وعبر وسائط إعلامية وفضاءات جديدة غير تقليدية منفلتة من رقابة السلطة على نحو ما، وتنتشر بسرعة فائقة محليا ودوليا، وسائل تعبيرية عابرة للقارات والحدود والطبقات الاجتماعية.إن السبيل الوحيد لتحقيق التغيير هو المزيد من التعبير الحر من جهة الجماهير المهمشة المسحوقة، والمزيد من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الموجهة، هذا الذي يمكن أن يعجل بزوال حالة التسلط وإنهاء المأساة. إنه منطق اصطدام إرادتين متناقضتين يرتبط وجود هذه بزوال الثانية أو على الأقل إخضاعها لإرادتها إكراها لإحداث التغيير بالإكراه. لقد تقلصت المسافة بينهما إلى الصفر وبدأت الأحداث تتسارع والتحديات تكبر بينهما في غياب تام للمؤسسات الوسيطة، التي تلعب في المجتمعات الديمقراطية دور صمام الأمان المخفض للتوتر ولأي انحراف نحو العنف.إن لغة التخاطب بين هذا الجيل الجديد، بعد ثماني سنوات من حراك حركة 20 فبراير، وبين سلطة يمينية استئصالية ومكابرة، حتى لا نقول انتحارية، ليس فيها أي دعوة للقطع مع الملكية التنفيذية، ولكن لتعريتها وكشف دورها في مأساة هذه الشريحة الأكثر تضررا في المجتمع، وهي غالبية كانت صامتة وعازفة عن الشأن العام، كما جاء في فيديو كليب “عاش الشعب” و”مول الكاسكيطة” و”مول الحانوت”. للأسف، السلطة والنخبة الخاضعة طوعيا لها تنظر لهذه الشريحة بازدراء وانتقاص، وبدل أن تحاول فهم الظاهرة ومعالجة الأسباب والأسس، ذهبت تنعتها بأحقر الأوصاف والنعوت. هذا هو نوع العمى السياسي الذي يدفع الأنظمة نحو نهايتها كما حصل مع الملكة ماري أنطوانيت، زوجة الملك لويس السادس عشر قبيل الثورة الفرنسية حينما وقف الفقراء عند أبواب قصرها يطالبون بالخبز، فكان أن ردت وقالت “إذا لم يكن هناك خبز للفقراء، دعهم يأكلون كعكا”. يحكى عنها أنها كانت هي من يحكم البلاد وليس زوجها الملك، وأنها كانت لا تأخذ برأي ومشورة عقلاء الدولة ولا تستجيب لمطالب الطبقة المسحوقة لتجنب الكارثة، وكانت متهورة تبذر بإسراف المال العام في ملذاتها ونزواتها. كان مصيرها ومصير الملك وعائلتها الإعدام بالمقصلة عقب اندلاع الثورة عام 1789.مثال آخر عن عدم اتخاذ الوضع العام في البلاد على محمل الجد وقمع الشعب، خاصة طبقته المسحوقة والمعدومة، وتسليم شؤون الدولة والحكم لشخص أو مجموعة ممن لا يعملون من أجل استمرار المُلك من المقربين من الجالس على العرش، هو حكم آل رومانوف، آخر أسرة ملكية حكمت روسيا قبل الثورة البولشفية بقيادة فلاديمير لينين، في عهد الإمبراطور نيكولا الثاني. فقد كانت زوجته، ألكساندرا فيودوروفنا، هي من يتحكم في شؤون الدولة واتخذت غريغوري راسبوتين (الفاجر باللغة الروسية)، شخصا مشعوذا وسكيرا ادعى الرهبنة والسحر وتحقيق الخوارق، اتخذته مقربا منها حتى أصبح صاحب السلطة النافذ والمهيمن على شؤون الدولة والعائلة. لقد انتهى الجميع بالإعدام وسقطت الملكية إلى الأبد، عائلة رومانوف وراسبوتين.ما الذي تغير منذ 2011، وما هي القيمة التي أضافها وجود البيجيدي في الحكم لولايتين متتاليتين؟لقد تغير ميزان القوة بين السلطة الحاكمة والمجتمع لصالح هذا الأخير، إذ لم تقدم السلطة أي حلول لمشاكل المجتمع وظنت، عن خطأ منها وسوء تقدير، أن سياسة القمع والاعتقالات وفتح سجون جديدة وتكميم الأفواه وتخويف الناس كفيلة بجعل الشعب يستسلم لقدره، كما أن سياسة الأمن مقابل الحرية والكرامة والعدالة لم تنجح، حيث زادت حدة الغضب والاحتجاجات القطاعية في المدن والقرى، داخل الوطن وفي المهجر، وارتفع سقف انتقاد المؤسسة الملكية والجالس على عرشها في وسائل التواصل الاجتماعية وأشكال الإبداع الفني المختلفة، الراب والفيديوهات والقنوات على الإنترنت والبيانات، وبشكل غير مسبوق وقاس.كما شهدت السنوات التي تلت حركة 20 فبراير والربيع العربي عام 2011 تراجعا خطيرا لدور الأحزاب وضعف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وانحيازها وخضوعها لتوجيهات هذا الجناح اليميني المتطرف في السلطة، وسجلت أيضا اختراق السلطة لقطاعات كانت من قبل عصية على التطويع، المحاماة والصحافة، بما فيها نقابة الصحفيين، وهذا ما شهدناه في الكثير من القضايا والملفات المعروضة على القضاء للمحاكمة، حيث انبرى، وبشكل سيئ وغير مهني، محامون وصحافيون لمهاجمة كل من يقف في وجه تطرف هذا الجناح ويروجون لروايات السلطة وسياساتها، مثل ما جرى مع شباب الريف ومناطق أخرى والصحفيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وهاجرالريسوني، وأيضا متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين حول حادثة تعود إلى ربع قرن، وتمت تبرئته منها بحكم نهائي ومن قبل هيئة الإنصاف والمصالحة.ومما يلاحظ أيضا أن السلطة الحاكمة لم تستطع استقطاب نخب جديدة وتكتفي بتدوير القديم منها في حلل جديدة كما هو شأن تعيين شكيب بن موسى على رأس لجنة النموذج التنموي بعد سنوات من النسيان في باريس، كما أنها لم تنجح في تقديم قوة سياسية تملؤ حالة الفراغ السياسي وتواجه بها خصمها السياسي، التيارات الإسلامية، والشعب الغاضب في الشارع وفي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جاءت بحزب الأصالة والمعاصرة (البام) ولم يفلح إلا في اغتناء قياداته وتربعهم على مناصب عالية في مؤسسات الدولة، وانتهى بهم المطاف إلى ساحة القضاء لإنهاء صراعاتهم حول الزعامة. ثم دفعت بوجه آخر للواجهة لعله يحقق ما فشل فيه حزب الأصالة والمعاصرة، وهو الملياردير عزيز أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار في ظاهرة هي الأولى من نوعها، وهذا مما تحقق للسلطة خلال السنوات التي تلت الربيع العربي، هندسة الأحزاب وصناعة قياداتها، حالة أحزاب الاستقلال والتجمع والدستوري والعدالة والتنمية و(البام) والاشتراكي، وهناك محاولة مع التقدم والاشتراكية، الأمر الذي لم يتحقق وكان رد الشارع في مقاطعة محطات أفريقيا المملوكة لأخنوش.ورغم الانتقادات التي وجهت لحزب العدالة والتنمية على موقفه من حركة 20 فبراير وعلى القرارات السياسية والاجتماعية التي اتخذها خلال ترؤسه للحكومة الأولى، 2012-2016، فقد كان الحزب يدافع عن خياراته وتجربته ومواقفه بقوة، ولكن بعد التجربة المريرة لحكومة “البلوكاج” وإبعاد عبد الإله بنكيران عن رئاستها كرها وعن رئاسة أمانة حزبه غدرا وقبول رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، شروط السلطة طواعية، بما فيه تحالفه مع الاتحاد الاشتراكي وخضوعه لاشتراطات غريمه أخنوش وهندسة الحكومة الجديدة، وهو ما كان بنكيران يرفضه بشدة بدعم مستميت من نبيل بن عبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، بعد كل هذا يتبين اليوم بأن الحزب قد أضاع فرصة تاريخية لا تتكرر دائما كانت ستخلد الحزب وأمينه العام بأن كان له الدور في جعل السلطة الحاكمة، كما وقع في أوروبا، تقبل بملكية دستورية حقيقية واعتماد دستور على هذا الأساس، ملكية تسود ولا تحكم. يدرك بنكيران وحلفاؤه في الحزب هذا ويعلم أن من أطاح به، بدعم من إخوة له في الحزب، هم رجال الجناح اليميني المتطرف والاستئصالي في الدائرة الضيقة للسلطة الحاكمة، العفاريت والتماسيح حسب تعبيره، وربما لو اندلعت حركة احتجاجية جديدة بالمغرب، ربما أقول قد يكون له تقييم آخر للموقف، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.لماذا لا نشهد تحالفا للقوى الحية في المجتمع، يسارية وإسلامية، على أرضية ديمقراطية، مثلما كان الأمر مع الكتلتين الوطنية والديمقراطية؟لا يمكن أن يحصل تحالف بين اليسار والإسلاميين على أرضية مشتركة لأسباب عديدة، أولا لأن اليسار قبائل والإسلاميين طوائف، منهم من هم جزء من أدوات السلطة ومنهم من يحلم بالدولة التائبة وعودتها لرشدها وينتظر هذه الرؤيا منذ عقود، مما دفع بالبعض إلى التفكير في فتح قنوات اتصال مع السلطة للعب دور المنقذ، حسب زعمهم واعتقادهم، مما هو قادم من اضطرابات كاسحة بعد أن انتهى دور حزب العدالة والتنمية وحققت السلطة به مرادها.لقد تغيرت الظروف السياسية والتاريخية التي طرحت مبادرة الكتلتين الوطنية والديمقراطية، لأن ميزان القوة تغير اليوم لصالح الجناح اليميني الاستئصالي في السلطة ودفعت جل الأحزاب لتقديم حساب الإفلاس وتحولت لمشتل سياسي منتج لفرص المناصب والمكاسب. هناك واقع اجتماعي وسياسي جديد وفاعلون جدد خارج النسق المؤسسي الرسمي وخارج البراديكم التقليدي الذي وضعته السلطة منذ بداية عهد الملك الراحل الحسن الثاني، فاعلون وسلطة يقفان اليوم وجها لوجه في تحد خطير وبدون وسطاء.لم تعد المبادرة للأحزاب حتى تقيم تحالفا حقيقيا على أساس برامج ومشاريع مجتمعية ترغم السلطة الحاكمة على قبول التغيير نحو ديمقراطية حقيقية وملكية مقيدة بنص الدستور، تسود ولا تحكم، كما كانت تطالب بذلك منذ الاستقلال. التحالفات التي نراها هي تحالفات انتخابية لكسب المقاعد في البرلمان ورئاسة الجهات والأقاليم والبلديات، وهي للأسف تحالفات مصالح بين أحزاب في الحكومة وأحزاب في المعارضة، مثال ذلك حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في طنجة لانتخاب رئيس الجهة، والأمثلة كثيرة ومخجلة.يكفي النظر في شكل وطبيعة الحكومة الحالية وتناقضاتها وصراعاتها وغيابها عن هموم المواطنين ومآسيهم الحقيقية، وتنصلها من تحمل مسؤوليتها أمام تغول الجناح اليميني المتطرف في السلطة الحاكمة الذي سحب منها ملفات حيوية ومهام وطنية كان عليها أن تتولاها بموجب الدستور ومسؤولياتها السياسية والالتزامات التي قطعتها على نفسها أمام الناخبين، كما نلاحظ اليوم مع اللجنة الخاصة للبرنامج التنموي التي ستقوم بعمل هو من صميم اختصاص الحكومة ومسؤولياتها السياسية والدستورية.ما رأيك في دور جماعة العدل والإحسان اليوم في معادلة الانتقال نحو الديمقراطية، وهل تملك هذه الإمكانية بعد تراجع جميع القوى السياسية والاجتماعية التقليدية؟ليس لجماعة العدل والإحسان أي دور إلا إذا أرادت أن تكون مجرد رقم من بين أرقام أخرى كما حصل مع حزب العدالة والتنمية، تنتهي مرحلة “العذرية السياسية”، ثم سرعان ما تستفيق وقد انتهى دورها في تجسير مرحلة اقتصادية واجتماعية وسياسية مشحونة بالأزمات والاضطرابات. لسوء حظ الجماعة أنها تواجه اليوم تحديات عدة، أولها وهو تحد بنيوي داخلي، حيث أنها لم تلتمس طريقها بعد رحيل المرشد المؤسس الراحل عبد السلام ياسين، وأعتقد أن ما يؤخرها عن أي ظهور سياسي واجتماعي بارز، هو النقاش الداخلي بين أطرافها وغياب تصور محدد لما يمكن أن تقوم به في مرحلة ما بعد التغيير، كما سبق أن قلت في مناسبة سابقة، الجماعة تخاف من النجاح لأنها لم تعد له العدة المطلوبة من مشروع وكفاءات.إن القوانين الاجتماعية والسنن الكونية والإحيائية تربط أي خلق أو ظاهرة بشرط الزمن المحدد وعامل الوقت المقيد حتى يكتمل تخلقه وتكوينه، وليس في الزمن المطلق كما هو حال الجماعة وقد أوشكت على نصف قرن منذ تأسيسها، فلا هي انخرطت في المشاركة السياسية كما فعل حزب العدالة والتنمية وحاول حزب الأمة وحزب البديل الحضاري، ولا هي صنعت وقادت ثورة جياع وفقراء ومظلومين وتحملت مسؤوليتها السياسية والتاريخية وضريبة التغيير. إنها تنتظر المبادرة من الشعب حتى لا تصطدم بالجناح الاستئصالي في السلطة. إن دور القوى الاجتماعية والسياسية يبرز خلال الأزمات والأحداث الكبرى لتتحمل مسؤوليتها التاريخية بتبنيها نضاليا وواقعيا وجماهيريا لقضايا الشعب، لا أن تقفز عليها بانتهازية وتستفيد منها سياسيا وانتخابيا كما فعل حزب العدالة والتنمية، وقد صرح بذلك أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران بشأن حركة 20 فبراير.التحدي الثاني الذي تواجهه الجماعة هو أن هذه المرحلة، ونحن على مسافة قريبة جدا من انفجار موجة ثانية من الثورات العربية، لم يعد للأحزاب ولا للقوى الاقتراحية والوسيطة أن دور يذكر في قيادة واحتضان هذه الموجة بسبب خطأ ارتكبته السلطة حين حيدتها من الصراع، فانكشفت سياسات السلطة عارية أمام عموم الشعب المغربي الغاضب، من الريف إلى جرادة والأقاليم الصحراوية، ومن الإضرابات القطاعية المتعددة إلى حملة طرد الصحفيين والحقوقيين والمناضلين إلى فيديو كليب “عاش الشعب” وأغاني الألتراس في مدرجات ملاعب كرة القدم المعبرة عن معاناة عموم الشعب. أما التحدي الثالث، وحتى لو تحولت الجماعة إلى حزب سياسي بمرجعية إسلامية، فإن ما كان يسمى بحركات الإسلام السياسي وصلت لنهاية مشروعها ووجودها، وأوشكت، بل وصل بعضها، للتحول إلى أحزاب علمانية هي أشبه لنظام إسلامي رسمي له مصالحه ومبرراته السياسية والفقهية ووضعه الاجتماعي، ولكنه فقد مبرر نشأته الأولى وهي أنه كان يحمل شعار تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة حكومة إسلامية تحتكم لأحكام الإسلام.لقد طرح الغرب وباحثوه في مراكز البحوث الاستشراقية، فرنسا وأمريكا وبريطانيا تحديدا، منذ ثمانينيات القرن الماضي مع بروز الظاهرة الإسلامية، خاصة بعد الثورة الإيرانية عام 1979 واغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981 من قبل الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي، واندلاع الجهاد في الكثير من المناطق في العالم، بما فيه أوروبا، أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك، مشروع دعم ظهور حركات جهادية سنية لمواجهة سياسة تصدير الثورة من قبل القادة الجدد في طهران نحو العالم العربي من جهة، وتشجيع الحركات الإسلامية الدعوية، من جهة أخرى، إلى التحول لمؤسسات حزبية وإلى العمل والمشاركة السياسية وإدماجها في النسق السياسي الرسمي، لتضفي شرعية على أنظمة بدأت تترهل وتواجه تحديات كبيرة، وتواجه بها فيما بعد، بعد مشاركتها في السلطة، حركات الإسلام الجهادي التي خرجت عن السيطرة وبدأت تستهدف الغرب نفسه كما وقع مع تفجيرات نيويورك عام 2001 من قبل القاعدة. هذه التجربة، ما يسمى بالإسلام السياسي، انتهت إلى الفشل وفقدت مبرر الاستمرار في إعلان نفسها حركات إسلامية بنفس الهوية والمشروع الذي جاءت به عند تأسيسها.هل لك من قراءة للعفو الملكي كتدخل للحد من حالة الاحتقان كما حصل مع الصحفية هاجر الريسوني؟أعتقد أن العفو الملكي اليوم هو تعبير عن الوجه الآخر للصراع الدائر داخل الحلقة الضيقة للسلطة الحاكمة، وهو الوجه الذي يرى في إنهاء وتسفيه دور الأحزاب والنقابات والهيئات المدنية الوسيطة خطورة على الملكية، وقمع الحريات وامتهان كرامة المواطنين وفتح أبواب السجون لكل صوت يغرد خارج السرب، يرى أن كل هذا بدأ يضع الملكية، والملك شخصيا، أمام غضب وانتقادات شريحة مجتمعية مقهورة ومظلومة لا تخضع تعبيراتها لأي من المعايير التي تخضع لها النخب السياسية والحزبية والحقوقية العاملة داخل النسق المؤسسي الرسمي، أصوات تعبر خارج الصندوق وبلغة قاسية تمتح من آلامها ومعاناتها الاجتماعية والمعيشية وإحساسها بالمهانة والاحتقار (الحكرة).ما علاقة هذا بالعفو الملكي؟هناك حالة تقاطب حادة بين جناحين غير متكافئين، جناح يميني متطرف ومهيمن، حتى الآن، ومتحكم في أجهزة الدولة البارزة والتنفيذية، النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني بجميع مديرياتها، والقضاء وعائلات غنية تعيش على الريع وأيضا في قطاع واسع من الصحافة والمثقفين والأحزاب وشريحة انتهازية من المحامين، كما تجلى ذلك واضحا في محاكمات شباب الريف وحميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وعبد العلي حامي الدين وهاجر الريسوني وقضايا أخرى مثل الحريات الفردية وزواج المثليين والعلاقات غير الشرعية واللغة العربية وأحكام القرآن حول الميراث وتعدد الزوجات وولاية الأب، حالة تقاطب شرس بدأ يوسع الهوة بين المجتمع المغربي وبين هذا الجناح المتطرف الاستئصالي في السلطة، مما قد يدفع البعض نحو انزلاقات وصدامات على الهوية والانتماء، كما حصل في كثير من الدول العربية خلال نصف قرن الماضي.نفس الصراع بين قطبي السلطة الحاكمة خلق صراعا أيضا في المجتمع لا تخفى معالمه ومظاهره اليوم، ويزداد حدة كلما ارتفع سقف المطالبة بتحرير المجتمع من أي انتماء ديني أو تقيد بتعاليمه وقيمه. إن التطرف في التفسخ يولد تطرفا في التدين، والخطر الأكبر أن السلطة، في شقها الاستئصالي، تدعم تيارات ومنظمات التحلل الخلقي بدعوى التحرر والقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الفردية والجماعية، فيما الشق الثاني الإصلاحي، يحاول كلما استطاع، مثل حالة الصحفية هاجر الريسوني، إقناع الملك بخفض حالة الاحتقان عبر كشف تلاعبات وتصرفات غريمه في الدائرة الضيقة للحكم وبيان الظلم الذي لحق بها.هل مسطرة العفو الملكي محكومة بكل هذه التعقيدات؟نعم، وإلا لماذا لم يصدر حتى اليوم عفو ملكي في حق الصحفي بوعشرين والمهداوي وشباب الريف وجرادة وزاكورة والعيون على سبيل المثال؟ الجواب الأكثر واقعيا هو ليس لأن الملك لا يريد فيما أعتقد، وقد سبق أن أدان محاكمات 16 ماي 2003، ولكن لأن صوت صقور الحكم عال اليوم وصفه أكثر تنظيما وقوة وطنيا ودوليا، فرنسا وأمريكا وإسبانيا. قضية بوعشرين على سبيل المثال، ليست مع الملك، ولكن، بتعبير المستشار الملكي السابق الدكتور عباس الجراري، مع “مسامير المائدة”، من دعاة الاستئصال في السلطة والأوليغارشية الحليفة وبقايا الصحافة واليسار اليميني والمثقفين المتجولين.إن القادرين على جعل الملك يصدر عفوا لفائدة الصحفي بوعشرين والمهداوي وشباب الريف وآخرين وإنهاء المتابعة الهزلية لحامي الدين وإنهاء المتابعة العبثية لأنوزلا ومنجب وآخرين ممن تصدح أصواتهم اليوم مطالبة بالكرامة والحرية مثل “مول الكاسكيطة” و”مول الحانوت” ومغني الراب، خاصة فيديو كليب “عاش الشعب”، القادر على ذلك هو الجناح الإصلاحي المعتدل في الحلقة الضيقة القريبة من الملك من أصدقاء الدراسة ومن حولهم، الذين يدركون خطورة سياسة الاستئصال والأرض المحروقة على استقرار الدولة المغربية ومستقبل الملكية والسلم الاجتماعي.للأمير هشام العلوي، ابن عم الملك، خرجات إعلامية ومواقف سياسية تجاه الوضع العام ببلادنا، كما له قراءة للوضع العربي منذ اندلاع شرارة الربيع العربي عام 2011، فما رأيك فيما يقدمه من وجهة نظر؟ما يقع للأمير هشام العلوي ليس جديدا في تاريخ دسائس القصور ويعرف ذلك جيدا وعايشه عن قرب، ولكن الغريب هو أن يصبح ذلك خارج أسوار القصر وتنبري لمهاجمته ومطاردته قيادات حزبية وأجهزة وصحفيين وكان ذلك خطأ جسيما وقعت فيه المؤسسة الملكية حينما تخلت عن واحد من أبنائها، وكان في الترتيب الثالث دستوريا للجلوس على العرش. يعلم الأمير جيدا بأن المُلك عقيم وبأن السلطة، كما قال الملك الراحل الحسن الثاني في أحد حواراته الصحفية مجيبا عن سؤال حول رأيه بخصوص المهدي بن بركة، “خطأ بن بركة في أنه لم يفهم بأن الحكم، خلافا للرياضيات، معادلة غير قابلة للقسمة”. نقول اليوم، حول الوضع القائم، إذا كانت السلطة غير قابلة للقسمة، فإنها قابلة للاختطاف.إن تحول الملكيات عبر التاريخ البشري من حكم مطلق إلى ملكيات دستورية لم يكن برغبة منها ولا بتغير في تفكيرها ونظرتها للحكم أو لمطالب الشعب ولم تتنازل عن صلاحياتها التنفيذية وامتيازاتها طواعية، وإنما كان هذا التحول تحت ضغط قوى التغيير والأثمان الباهظة التي دفعت من أجل ذلك، وإذا أتيحت لها الفرصة لإعادة الحكم المطلق، فلن تتردد.لقد قبل الحسن الثاني بعبد الرحمن اليوسفي وزيرا أولا عام 1998 ليس لأنه أصبح ديمقراطيا إصلاحيا، ولكن لأنه رأى في ذلك الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الملكية من السكتة القلبية وترضية بعض حلفائه في الغرب وضمان انتقال سلس للحكم إلى ولي عهده عام 1999، كما أن الملك محمد السادس لم يسلم عبد الإله بنكيران رئاسة حكومة 2012 لأنه اقتنع بحكم الإسلاميين، ولكن لتجنب الملكية أهوال وبركان الربيع العربي وغضب حركة 20 فبراير 2011 الذي عم ما يزيد عن (93) مدينة وقرية مغربية، وكان لحزب العدالة والتنمية وأطراف أخرى، ولبنكيران تحديدا، الدور البارز في إجهاض هذا الحراك.ما رأيك فيما يقدمه ابن عم الملك من وجهات نظر؟الملاحظ في مواقف الأمير هشام منذ خروجه من القصر قبل عقدين من الزمن وخرجاته الإعلامية هو أنه لم يكن واضحا وحاسما بما يكفي حول الدور الذي كان يريده لنفسه للنهوض بوطنه، وإصلاح العلل التي ألمت بالمؤسسة الملكية كسلطة تحولت من المركز إلى الهامش. إن المطالبة بالإصلاحات الدستورية وبدور جديد للملكية في الحياة السياسية المغربية، كعنصر استقرار، لا يكفي، وكان عليه أن يذهب إلى ما هو أعمق من ذلك، حتى يقنع النخبة المعارضة الجديدة بتصوره للأزمة واقتراحاته السياسية للخروج، منها والتعبير عن التزام واضح وكامل للدور الذي يريد أن يلعبه.لقد ظهر في كثير من المناسبات مترددا رغم أنه في أحايين أخرى رفع سقف الانتقاد للسلطة الحاكمة عاليا، ولم يخف أفق موقفه في حالة كابرت الملكية واستمرت في عنادها ضدا على رغبات الشعب المغربي وعلى اتجاه الأحداث وحتمية التاريخ. الأمير هشام ملكي رغم رفضه للقب “الأمير”، وبالرغم من أن أفكاره مشبعة بالمرجعية الجمهورية كنظام حكم أكثر استقرارا وضمانا لمبادئ حقوق الإنسان والحكم الراشد والتداول السلمي على السلطة ولدور الشعب في التعبير الحر عن إرادته واختياراته، فهو بين ماض لعب عمه الراحل الحسن الثاني، نموذج الملك القوي ورجل الدولة كما يقول، دورا كبيرا في بناء شخصيته وتشكيل وعيه السياسي وبين جده من أمه، رئيس الوزراء اللبناني الراحل رياض الصلح، الشخصية الليبرالية والإصلاحية، من جهة، وبين تأثره بالقيم الغربية في الحكم ونمط الحياة من جهة أخرى.لقد كان ممكنا قبل سنوات أن يكون للأمير هشام دور بارز في بناء مغرب جديد، خاصة مع أحداث الربيع العربي واحتجاجات حركة 20 فبراير قبل ثماني سنوات، إلا أنه بقي بين المفكر والسياسي ولم يحسم الدور الذي يريده لنفسه، خوفا مما ألصق به عنوة من قبل خصومه في الحلقة الضيقة حول الملك وأدواتها الموزعة في مواقع مختلفة داخل وخارج البلاد، هو أن يقال عنه إن له مطامع في العرش.لقد استعجل أيضا الحكم على نتائج الربيع العربي وأصدر أحكام قيمة على تجربة الحركات الإسلامية في الوطن العربي، خاصة في مصر، رغم أن تقييم تجربة هذه الحركات بمنظور ومقاربة واحدة فيه الكثير من التعميم والسطحية والتجني من الناحية السياسية والعلمية، وبقي حكمه ملتصقا بحركات الإسلام السياسي وبهذه المرحلة التاريخية من الربيع العربي، فيما أن الإسلام، دعوة ودولة، له حركات أخرى خارج النسق الحزبي والمؤسسات الرسمية تتهيأ للمرحلة الثانية من الربيع العربي. إنه من المبكر جدا تقديم أي حكم علمي وتقييم سياسي لما جرى ويجري في البلاد العربية والعالم.
تاريخ النشر: 2019-12-21 22:00:30
الناشر/الكاتب: سليمان الريسوني
اليوم 24 – تفاصيل الخبر من المصدر